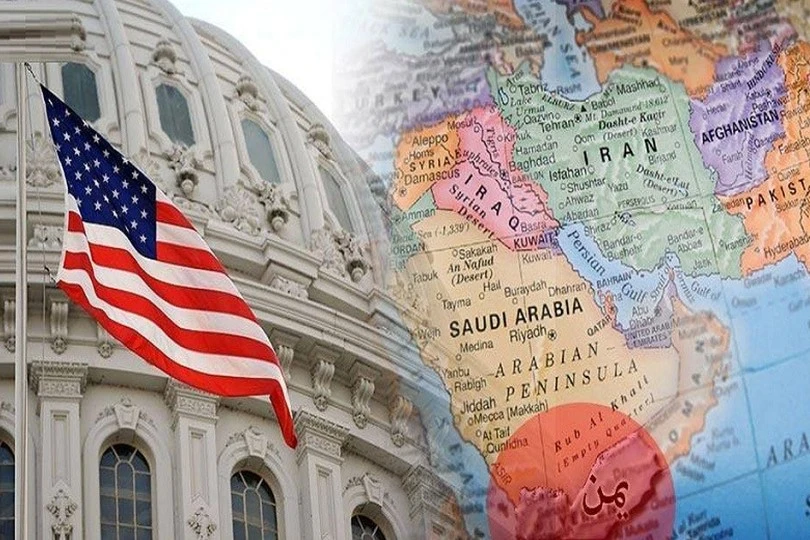في مثل هذه الأيام من آخر كل عام ميلادي، يكون الشّغل الشّاغل لأكثر الأمم، هو إحصاء الإنجازات وتقديم كشوف حسابٍ لما تمّ إنهاؤه من مشاريع وإنجازه من مخطّطات؛ لتثمين سعي من أدى واجبه، وتقريع ومعاقبة من تهاون في أداء ما أوكل إليه. ورصد ما يؤمَّل إنجازه ويُرجى تحقيقه في العام الجديد…
ويفترض أن نكون نحن المسلمين أولى النّاس بمثل هذه الحسابات والنقاشات التي تصلح دنيانا وتمكّن لنا في الأرض، لأنّ قرآننا يقول: ((وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُون)). لكنّنا مع كلّ أسف اخترنا أن نكون –إلا قليلا- ممّن يحبّون أن يُحمدوا بما لم يفعلوا؛ فانشغلنا بالمجاملة عن المحاسبة، وبالشعارات عن الإنجازات!
على المستوى الفرديّ؛ يُفترض أن تكون الأيام الأخيرة من كلّ عام، مناسبةً للتفكّر والتدبّر والاعتبار بسرعة انقضاء الأعمار، وفرصةً لمحاسبة النفس عمّا قدّمته خلال عام يتهيّأ للرّحيل، وخلخلتها لتتهيأ لعام جديد تؤمّل أن يكون أفضل لأنّه يقرّب للقبر والحساب أكثر.. مرور الأعوام أصبح سريعا سرعةً تهزّ القلوب والأرواح…
العام لو نظرنا إليه بحساب الأيام والساعات فإنّنا نجد أنّه يتكون من أكثر من 8700 ساعة، وكلّ ساعة منه يمكن أن ترحل محمّلة بأعمال صالحة تشفع للعبد وترفعه عند الله… لكنّنا لا نشعر بهذا العدد الكبير من السّاعات حتى ينقضي وينفلت من بين أيدينا، وتزداد حسرتنا حينما ندرك أنّنا لم نستفد من كلّ تلك السّاعات شيئا يستحقّ الذّكر!
لو نظرنا إلى واقعنا بكلّ صدق، فسنجد أنّنا ما عدنا نعتبر بتوالي السنين، كلّنا نتكلّم بألسنتنا عن سرعة مرور الأعوام، لكنّ قليلا منّا من يعتبر ويدّكر ويحاسب نفسه، ويسأل في نهاية كلّ عام: ما الذي أنجزته في هذا العام؟ ما الذي قدّمته لنفسي وأسرتي؟ ما الذي قدّمته لديني وأمّتي؟ ما الجديد النّافع الذي أضفته إلى حياتي؟ ما القديم الضارّ والمهلك الذي تخلّيت عنه؟
الأمم الكافرة من حولنا أضاعت دينها واتّبعت الشّهوات، لكنّها تقيّم دنياها ويحاسب بعضها بعضا حسابا دقيقا في ذلك… ونحن يفترض أن ننافس الكافرين في جدّهم في إصلاح ما هو نافع من دنياهم، لأنّهم بذلك سيطروا على العالم واستعبدونا، ونجتنب في المقابل إضاعتهم لدينهم وانحدارهم في مستنقع الشّهوات… لكنّ كثيرا منّا مع كلّ أسف لم يتّبعوا الكافرين في إقامة دنياهم، إنّما اتّبعوهم في إضاعة الدّين واتّباع الشّهوات!
كثير من المسلمين في مثل هذه الأيام الأخيرة من العام الميلاديّ، لا يلتفتون إلى لغة الحساب والعتاب وتقييم الحصاد، ولكنّهم يلتفتون فقط إلى اتباع النّصارى في احتفالهم بالكريسمس والريفيون، ويظنّون أنّ ذلك هو التطوّر والانفتاح وتلك هي الحضارة معها الأيام والليالي الملاح.. ولو أنكرت على أحدهم إنفاق ماله على الكريسمس أو على الريفيون، لأجابك بكلّ استعلاء: “إنّنا في العام 2026”!
وكأنّه يقول لك: “هذا الكلام في الحلال والحرام، وعن حرمة مشابهة النصارى واتباع سننهم، قد فات وقته”! لكنّه ينسى أن يسأل نفسه ما الذي يقدّمه لأمّته وللبشرية أو حتى لنفسه عندما يحتفل بالكريسماس والريفيون؟ عندما يقضي عطلة نهاية السّنة في تونس أو في بعض الفنادق هنا وهناك المشتهرة بإحياء مثل هذه المناسبات على النّمط الغربي!؛ كم درجة يكون قد صعد في سلّم الحضارة؟!
هؤلاء الذين يقلّدهم من النصارى، لا يعرفون دينهم إلا مرّة في العام، ويحيونه بتلك الطّريقة المزرية، لأنّهم وجدوه دينا محرّفا مشحونا بالأغلال والآصار مزيجا من أهواء قساوستهم على مرّ العصور، يصادم العلم والعقل، لذلك أبعدوه عن حياتهم وسجنوه في الكنائس وأصبحوا لا يلتفتون إليه إلا مرّة في العام أو مرّة في الأسبوع؛ فهل دين هذا المسلم الذي يتشدّق بالحضارة مثل دين النّصارى حتى يتعامل معه كما يتعاملون مع دينهم؟! الإسلام دين علم يتفق مع الفطرة والعقل وهو منهج حياة وليس طقوسا في المناسبات…
النّصارى يتذكّرون دينهم ليلة في العام، يعربدون فيها، ثمّ يعودون إلى دنياهم ليبنوها. أمّا بعض المسلمين، فيتّبعون النّصارى في احتفالهم، ثمّ يعودون إلى كسلهم وخمولهم وعطالتهم وتعطيلهم للحياة! ولو توقّف الأمر عند حدّ اتباع النّصارى في احتفالهم بميلاد من يزعمون أنّه ابن الربّ –تعالى الله عمّا يقولون علوا كبيرا- لما هان الأمر ولكان ((شَيْئًا إِدًّا * تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا))، كيف وقد اتبعهم بعض المسلمين فيما هو أكثر من ذلك!
قديما كان أعلام الأمّة يحذّرون من التشبّه بالنصارى في سمتهم وعاداتهم ويشدّدون التحذير من اتباعهم فيما هو من خصائص دينهم، لأنّ المشابهة في الأمور الظّاهرة تورث المشابهة بين القلوب، فكانوا يقولون: “لا يشبه الزيّ الزيّ حتّى تشبه القلوب القلوب”… ونحن الآن نرى في أحوالنا كيف بدأت القلوب تشابه القلوب بعد أن تساهلنا في مشابهة الأحوال للأحوال للأحوال والأعمال للأعمال!
نرى كيف أصبح كثير من المسلمين قلوبهم تشبه قلوب الذين كفروا في حبّ الدّنيا وعشق الحياة وكراهية الموت. ((وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ))…
بل قد وجد بين المسلمين من تعلّقت قلوبهم بالدّنيا ومظاهرها وأموالها ومتاعها أكثر من تعلّق الذين كفروا، وتفوّقوا على النّصارى في تعلّقهم بالموضة والأزياء إلى درجة العبودية، وإلى الحدّ الذي جعل بعض نساء المسلمين تصبح الموضة صنما يعبدنه من دون الله، يزنُ بعضهنّ بعضا بالموضة ويذكرنها أكثر ممّا يذكرن الله…
لديهنّ كلّ الاستعداد ليؤخّرهن صلاة يوم كامل -وربّما صلاة أيام- حفاظا على الزّينة. ولديهنّ كلّ الاستعداد لأن يتحمّلن لعنات الملائكة فيخرجن إلى الشوارع والأسواق متبرّجات بزينة مائلات متمايلات ضاحكات مقهقهات!
نرى كيف أنّ وجبات الطّعام أصبحت أهمّ عندنا -نحن المسلمين- من أوقات العمل ومن المواعيد بل وأهمّ من أوقات الصّلاة! وقت الطّعام مقدّس لا يتزحزح إلا عند الضرورة، بينما العمل يؤجّل ويُتعلّل لتركه، ووقت الصلاة يؤخّر لأتفه الأسباب… حالنا أصبحت تشابه حال من قال الله عنهم: ((يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَام)).
نرى كيف أنّ الموت الذي يعني لقاء الله والوقوف بين يديه أصبح يمثّل لنا كابوسا مرعبا، كما هي الحال عند اليهود والنّصارى: ((قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِين))…
أصبح الحديث عن الموت يزعج بعض المسلمين، ولا يطيقون سماعه، بل أصبح الواحد منهم لا يحبّ سماع موعظة عن الموت حتى في المقبرة بين القبور، يريد للإمام أن يرفع يديه بعد الدّفن مباشرة ويدعو للميت، ويطلق سراح النّاس ليخرجوا من ذلك المكان المخيف الذي يذكّرهم بمصير يتمنّون ألا يأتي إلا بعد ألف سنة…
نعم، طبيعيّ أن يخاف العبد من الموت، لأنّ الله سمّاه مصيبة، لكن شتان بين من يخاف الموت لشدّة سكرته وهول مطلعه، وحياءً من تقصيره، ووجلا من الله الذي فرّط في جنبه، وبين من يخاف الموت لأنّه لا يريد أن يقطع عليه سكرته بالدّنيا وتلذّذه بالحرام.
ينظر اليهود والنصارى إلى “الدّين” على أنّه زواجر وأغلال تقيّد الحرية وتمنع من تلبية شهوات النفس!
لذلك زهدوا فيه ولم يعطوه إلا فضول الأوقات… وهكذا أصبحت حال كثير منّا -نحن المسلمين- حين أصبحنا نتعامل مع الدّين كأنّه مطلب زائد في حياتنا، لا نحمل همّه: انتصر أم تراجع، حُكّم وطبّق أم عطّل وجمّد! ولا نعطيه إلا ما فضل من أوقات دنيانا، ولا نكاد نخدمه بشيء من جهودنا وأموالنا!
لا نهتمّ بتعلّم شرائع ديننا ومعرفة أحكامه، ولا نتحمّس كثيرا لإحياء شعائره، ونستثقل سماع الخطب والدّروس ونتجنب متابعة مقاطع الوعظ والتعليم، ونتهرّب من تعلّم حدود الدين متذرّعين بكثرة الخلاف وتعدد المذاهب! والحق أننا نتهرّب من تعلمها لأنها تحول بيننا وبين متعة أنفسنا بالشهوات….
أنسانا الشّيطان وأنستنا الدّنيا والأنفس الأمّارة بالسّوء أنّ حمل همّ الدّين وتعلّم أحكامه وخدمته، شرف ورفعة للعبد، وأنّ حدود الله إنّما شرعت لنبقى بشرا ولا ننحدر إلى درك الأنعام، ولأجل ألا تعمينا غشاوة الشهوات عن الدار الباقية، ولا تحجبنا عن خدمة ديننا!
مشكلةٌ عويصة أنّ كثيرا منّا يخسرون معركتهم مع أنفسهم في الحدّ الأدنى من التديّن، في المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها، وختم القرآن كلّ شهر، وإخراج الزّكاة في وقتها، وصوم رمضان عن المحرّمات قبل صومه عن الطيّبات، والحرص على لقمة الحلال والحذر من لقمة الحرام، وبرّ الوالدين وصلة الأرحام وإحسان الجوار وترك الظّلم، وغضّ البصر وكفّ اللّسان وتحصين الفرج…
هذا الحدّ الأدنى عجزنا عنه، كيف بفريضة نصرة الله ورسوله ونصرة الدّين ونصرة الحقّ؟ كيف بفريضة العمل لدين الله، وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ كيف بفريضة الوقوف في وجه الظّلم والفساد وتحمّل كلّ أذى في سبيل ذلك؟ الله -تبارك تعالى- أمرنا بالصلاة والصيام والزكاة والحجّ، لكن ليس هذا هو فقط الدّين! الدّين معركة حامية الوطيس يخوضها العبد لأجل دينه تستغرق عمره وتحرمه النّوم في كثير من الأحيان وتجعله يزهد في كثير من الكماليات والشهوات…
المؤسف أنّ كثيرا منّا قد ولّوا عن هذه المعركة الأدبار، لحساب تديّن هامشيّ انتقائيّ!
اليهود والنصارى خذلوا دينهم، وقالوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر، وتولّوا عن أنبيائهم فلم ينصروهم؛ فاليهود خذلوا موسى –عليه السلام- فقالوا: ((فاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ))، وخذلوا كثيرا من الأنبياء بعده، بل حاربوهم وقتلوا بعضهم…
والنصارى تركوا نبيّ الله عيسى - عليه السّلام - ليقتل، ولولا أنّ الله نجّاه ورفعه إليه لكان مصيره الصلب حتى الموت…
هكذا فعل اليهود والنصارى بأنبيائهم، وهو ما يفعله كثير من المسلمين الآن مع العلماء الربانيين والمصلحين الصابرين، قالوا لهم: واجهوا وحدكم الواقع، فنحن مشغولون بدنيانا، وقفوا وحدكم في وجه الفساد، فنحن لا نريد أن تمسّ دنيانا أو ينقص شيء من حظوظنا منها!
اليهود والنصارى تحايلوا على دينهم وشرائعهم واستباحوا كثيرا من المحرّمات، وكذلك فعل كثير من المسلمين الذين تحايلوا على الربا وتفننوا فيه وبنوا له مؤسسات ترعاه وتغري به وتروّج له وتذلّل سبله وتهوّن الإقبال عليه، وتساهلوا مع الزّنا وتركوا الطرق الموصلة إليه سالكة….
وحتى بعض المهلكات التي يحاصرها اليهود والنصارى في مجتمعاتهم، كالظلم والسرقة والغشّ والرّشوة والمحاباة؛ سرت بين المسلمين وأصبحت واقعا لا ينكره إلا القليل منهم!
اليهود والنّصارى استباحوا الفجور وعبّدوا الطّرق الموصلة إليه، فأشاعوا التبرّج والاختلاط وجعلوا للفساد عيدا سمّوه عيد الحبّ، وزيّنوا العلاقات خارج إطار الزّواج وجعلوها من لوازم الحرية ومن حقوق المرأة التي لا دخل للوالدين ولا للمجتمع فيها! وهكذا فعل بعض المسلمين الذين زيّن لهم شياطين الإنس والجنّ التبرّج والاختلاط والعلاقات خارج إطار الزّواج في المسلسلات والأفلام، وأصبح التبرّج واقعا مألوفا في أمّة يأمر كتابها بالحجاب والستر والاحتشام في آيات محكمة صريحة!
ووجد بين المسلمين من يحتفل بعيد الحبّ ومن يبرّر للعلاقات خارج إطار الزّواج بأنّها ضرورية للتعارف والتآلف! ومن يبرّر للاختلاط في الملاعب والمسابح بأنّه عادي ولا شيء فيه!
وشيئا فشيئا حتى فجعت الأمّة بمهرجانات للغناء والرقص الماجن لا تكاد تنتهي في بلد مسلم حتى تنطلق في بلد مسلم آخر!
معلومات الموضوع
الوسوم
مراجع ومصادر
- الشروق أون لاين