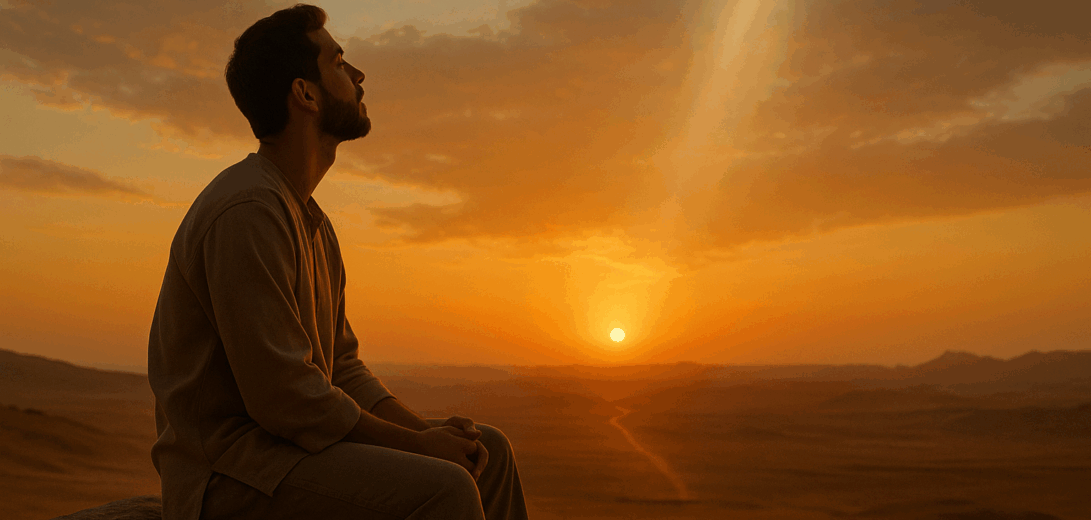كل فرد مقصود بقدره، مقدور له رزقه ونصيبه من الامتحانات في كل الأقسام: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ} [البقرة: 155].
بوصفنا مسلمين، لا بد أن نعي ونذكّر أنفسنا أن ثمّة أقدارًا لله تعالى مُدبَّرة، مقصودة، مرادة. ليست عبثًا ولا اتفاقًا، ولا خطأً سيصحّح بعد حين! وإنما هي سنن لمن فقه، وحياة لمن كان له قلب، ورسائل لمن ألقى السمع وهو شهيد. وأول خطوة في حسن التعامل معها هو إدراك أن كل الحياة أقدار، وكل الأقدار من الحياة.
تأمل في هذه القصة التي وردت في مسند الإمام أحمد:
«جلسنا إلى المقداد بن الأسود يومًا، فمرّ به رجل فقال: "طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم! والله، لوددنا أنّا رأينا ما رأيت، وشهدنا ما شهدت!"
فاستُغضب المقداد، فجعَلت أعجب، ما قال الرجل إلا خيرًا!
ثم أقبل المقداد إليه فقال: "ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرًا غيّبه الله تعالى عنه، لا يدري لو شهده كيف يكون فيه؟! والله، لقد حضر رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أقوامٌ أكبّهم الله على مناخرهم في جهنم! لم يجيبوه ولم يصدّقوه! أوَلا تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم، مصدّقين لما جاء به نبيكم؟ قد كُفيتم البلاء بغيركم! والله، لقد بُعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بُعث عليها نبي من الأنبياء، في فترة وجاهلية ما يرون أن دينًا أفضل من عبادة الأوثان. فجاء بفرقان فرّق به بين الحق والباطل، وفرّق بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل ليرى والده وولده أو أخاه كافرًا وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان، يعلم أنه إن هلك دخل النار، فلا تقرّ عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار، وهي التي قال عز وجل: {الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ}» ا.هـ.
فالمقصود إذن: ألا تتمنّى زمانًا غير زمانك، ولا حالًا غير حالك، ولا امتحانًا غير امتحانك، ولو بدا لك ظاهرًا خيرًا مما أنت فيه؛ فإنك لا تدري ما كنتَ لتكون أنت فيه! والله تعالى أعلم حيث وأنّى يجعل خلقه.
ومن سنة الله تعالى أن كل إنسان في هذه الدار ممتحن، سواء بالمحنة أو بالمنحة. وإذا راجعنا المعنى اللغوي للفظة "مَحَنَ" الفضّة أو غيرها من المعادن: قام بتصفيتها وتخليصها بالنار من الشوائب. فالممتحَن من المعادن هو: المصفّى المهذّب الخالص. من هذا التعريف يتبيّن أنه بعكس المدلول الشائع في الأذهان المقتصر على الاختبار بالشدائد والمصائب والتضييق فحسب، فالمحنة تعني مطلق الاختبار لمَعدِن المرء وتمحيص جوهره، وبالتالي يدخل فيها كذلك الامتحان بالنعم والمنح والسَّعة. وإنما ارتبطت دلالتها غالبًا بأوقات الشدة، لأن المرء يغفل غالبًا في أوقات الرخاء عن مفهوم الاختبار المستمر على الحالين: {وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ} [الأنبياء: 35].
المحنة تعني مطلق الاختبار لمَعدِن المرء وتمحيص جوهره، سواء في النعمة أو في الشدة
وتأمل في قول سيدنا سليمان عليه السلام لما جاءه عرش بلقيس في أقل من طرفة عين: {قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ} [النمل: 40].
أفليس العتب إذن على مَن يتوقع من الأشياء عكس طبائعها التي أُخبر بها، ويفترض فيها أدوارًا لم تُخلق لها، ويعلّق ثقته المطلقة حيث لا تحتمل التعليق؟ فمن الذي خلق لنفسه الإشكال بعدما أشكل عليه خلق نفسه؟ وكلّ ذلك مع أنّ الله تعالى أكرمنا بأن أبان لنا تمام البيان عن الطبائع والتكاليف والسنن في الكون والحياة والناس. فأقدار الله تعالى لا تصفع ولا تطعن ولا تباغت المؤمن، وما ينبغي لها ذلك، ولا يليق بجلال مقدّرها تبارك وتعالى. إنما هي سنن، لا تجد لها تبديلًا ولا تجد لها تحويلًا، لمن فهمها كما أراد من أجراها لا كما يريد من تجري عليه.
إننا نتعامل مع الحياة على أنها مستقر، وهي معبر؛ ومع الأقدار على أنها معادلات رياضية محسومة من جهة نظرنا، وهي أسرار غيبية عنا وإن كانت محسومة عند ربنا تبارك وتعالى؛ ومع النعم والمسرّات على أنها مسلَّمات بديهية ومكافآت مستحقة؛ ومع الكدر والشدائد على أنها المصائب الكبرى التي نتلهف لرفعها لنعود "للأصل" و"الحياة الطبيعية". ونتوقع السعادة الخالدة والراحة الدائمة من متاع عمّا قريب نفارقه، ونضع قائمة بالأماني المتعارف عليها منتظرين أن نتساوى في كل رزق وفي كل نصيب، لأن العرف جرى بأن هذه الأماني حق مكتسب للجميع ومحطات لا بد للكل من بلوغها. ونتوقع الدوام والاستقرار والثبات مما نحوز ونملك ومع من نعيش ونصحب، مع أنّ الأصل فيهم أنهم مردودون إلى بارئهم وعرضة للزوال بطبيعتهم؛ ونعوّل على ثبات الأحوال مع الناس، ونعجن أرواحنا بهم عجين من لا يطيق وجودًا بغيرهم، ونتعلق بتلابيبهم تعلق من لا ملجأ ولا منجى له بدونهم، فنلتمس الثبات ممن طبعه التقلّب، ونزهد في استجلاب الثبات ممّن بيده التقليب والتثبيت! ثم فيم نتطلب من الكون الثبات معنا على ما نهوى، ونحن لا نكاد نستقر في نفوسنا على حال ولا نثبت لربنا تعالى على طريقة؟!
كل حال حياة، ولا مفر من الحياة على كل حال
لذلك، فعلى كل مسلم أن يربي نفسه ويوطّنها على تصوّر الحياة المتكاملة بكافة تقلّباتها، بما يخفّف حدة الجزع من تغير الأحوال، ووطأة تزعزع النفس وطيرانها شُعاعًا عند كل نازلة، أو تحويل الحياة لمحطات انتظار تغير حال أو حصول حال. بل كل حال حياة، ولا مفر من الحياة على كل حال.
"إن الطبيب الحكيم لا يجاري العليل، ولكنه ينظر إلى العلة. وإن الله تعالى سبحانه - وله العزة - لا يبالي باصطلاح الناس، ولكنه ينظر مصلحتهم حين يعطي ويمنع. فليس في الأرض فقير قط إلا عند نفسه، ولو اطّلع كل إنسان على الغيب لما اختار إلا ما هو فيه."
[الرافعي – حديث القمر]